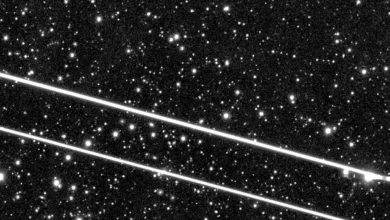فى الحرب … الأم وحدها لا تختبيء من الرصاص!
انقاذ الأطفال في مناطق القتال الساخنة، مثل مدينة الأبيض، ينتظر فتح الممرات الإنسانية
فى الحرب … الأم وحدها لا تختبيء من الرصاص !.
انقاذ الأطفال في مناطق القتال الساخنة، مثل مدينة الأبيض، ينتظر فتح الممرات الإنسانية
الأبيض: قرشي عوض
حين تدوي الانفجارات على غير موعدٍ، في سماء المدينة، يُسارع الجميع إلى الاختباء، إلّا الأمهات.. يخرجن إلى الشوارع نصف عاريات يصرخن باسماء أطفالهن في وقت لا يعلم فيه أحد من أيّ الاتجاهات ينهمر الرصاص.
معظم الأطفال خاصة في مدينة الأبيض، ماتوا في هذه الحرب، بسبب الشظايا المتناثرة من القذائف، حال ارتطامها بأهدافها غير المصوبة بدقّة، فيسقط بعضها فوق أسطح المنازل أو الأعيان المدنية.
والمشكلة التي تواجهها الأسرة المستقرة أنها لا تستطيع أن تحتفظ باطفالها أطول فترة ممكنة داخل منازل تفتقد لأبسط وسائل الترفيه، بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل.. فالمدارس القرآنية التي تم افتتاحها على مقربة في وسط الأحياء، تعمل ساعةً أو أكثر في اليوم، وفي الصباح فقط. أمّا فى بقية ساعات اليوم يتعين على الأسرة وبالتحديد الأم أن توزع اهتمامتها بين إعداد الوجبات الفقيرة ومراقبة الاطفال، مما يتطلب منها أن تطل في كل لحظة والأخري على الشارع، حتى تطمئن بانهم لم يبتعدوا عن المنزل كثيراً.
لكن، هناك أُسر لا تتوفر لها امكانية مراقبة أطفالها أثناء لعبهم، أو أن تحتفظ بهم في المنزل أطول فترة ممكنة، لأنهم ببساطة يتعين عليهم أن يعملوا حتى يساهموا في تدبير مصروف الأسرة.
وتتناقل مجالس القهوة النهارية، أنّ شظية قد شطرت طفلٍ يعمل في “درداقة” بالسوق الكبير، ولم يتعرف عليه غير أصدقائه الذين جاءوا معه من الأحياء البعيدة، فالكل كان مسرعا لينجو بنفسه، حين انفجرت تلك القذيفة، منذرة بالموت المؤكد بين ثانية وأخرى.. و في صبيحة اليوم التالي لأية غارة على المدينة ينطلق الأطفال يدفعون “درداقاتهم” إلى السوق ليخضعوا لاستغلال صغار التجار الذين يرحلون ببضائعهم من مكان إلى آخر، وتكون تلك الدرداقات التي يعمل عليها الأطفال باجور زهيدة، على أهبة الاستعداد لاخلاء السوق اذا لزم الأمر.
كما أن هناك أُسر بكاملها تقضي معظم يومها في السوق. فالرجل يعمل حمّال، والأم تبيع الأطعمة والقهوة والشاي، والأطفال يدفعون “الدرداقات” المُحملة بالبضائع. ودائما ما تقع المشاجرات بسبب أنّ طفلاً تعرّض لاستغلال أحد التجار أو طفلةً في مقتبل العمر تحرّش بها أحد المارّة، وهو لا يدري أنها وسط أُسرتها التي تنتقل في مثل الوقت للسوق. وحين تدوي صافرة قذيفة “الكاتيوشا” لا وقت للتفكير، حيث يمسك الأب والأم كل بيد طفلٍ أو إثنين، وينطلقون عكس اتجاه الصوت، ويدخلون أيّ منزل، حتى تنجلي المعركة، ثم يتدبرون أمر الذهاب إلى منزلهم في طرف المدينة. وعادةً تكون رحلة العودة للبيوت، سيراً على الأقدام، لأنّ المركبات العامة، تكون قد غادرت السوق.
ولكي نجنب الأطفال خطر نثارات الحديد المتطايرة من القذائف، هنالك حل وحيد، هو أن يبقوا في منازلهم طوال الوقت لأنّ لا أحد يمكنه أن يتنبأ بوقت الهجوم الذي يتم التخطيط له في مكان آخر، وبتقديرات مختلفة، عن حسابات الموت والحياة.
لكن، هل ذلك ممكناً، في وقت انسحبت فيه منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، التي تُقدِّم العون الإنساني، بعد أن نُهبت مخازنها، وتعرض موظفوها للقتل، بل، الشاهد أنّ بعض المنظمات العالمية، التي تساعد على تحسين سبل كسب العيش، لا تستطيع أن تتصرف، لأنّ المنظمات التي تقدم لها العون، قد أغلقت مكاتبها في الخرطوم، وهاجر موظفوها إلى مصر، أو إلى بلدانهم الأصلية. أمّا السلطات المحلية، التي تساعدها بعض المنظمات مثل الهلال الأحمر، لم تتعدى جهودها، حصر النازحين الذين يقيمون في المدارس، ليشكلوا عبئاً إضافياً على الخدمات الشحيحة، وقد وفروا احتياطي عمالة رخيصة، من الأطفال، ساهمت في تدني الأجور، فالطفل يدفع “الدرداقة” إلى مسافات طويلة، مقابل مبلغ بسيط، دون أن يتذمر أو يرفض، لأنّ غيره جاهز أن يقوم بهذه المهمة.
انقاذ الاطفال في مناطق القتال الساخنة، مثل مدينة الأبيض، ينتظر فتح الممرات الإنسانية التي تُمثل مُجرد بند، ضمن إجراءات بناء الثقة، بين طرفي الحرب التي توصلت اليها جولة المفاوضات الأخيرة في منبر جدة، رغم أنها قد انفضت بدون اتفاق وقف اطلاق نار، لتقديرات تخص الجهات المتحاربة، ليس لها علاقة بحياة الناس العاديين ، فى الوقت الذى يسعى فيه طرفا النزاع، لتحسين موقفه التفاوضي، ويبحث عن منصة يقف عليها، ولا يعنيه كثيراً إن كانت مشيدة من جماجم الأطفال. فالدعم السريع، يسعى لتأمين مكاسبه التي حققها في ميدان القتال، والجيش يعمل على استرداد كرامته المهدرة، والكل يُرمي في فوهة النار، لهوة من الاجساد الغضة الطرية، ويبحث عن أخرى من خلال تجنيد المستنفرين، أو إغراء شباب القبائل الحالمين بالثراء، عبر النهب والسلب، وفي “ارتكازات” الشوارع، يقف خلف أسلحة الدمار والموت، أطفال لم يتجاوزوا الخامسة عشر، أو السادسة عشر من العمر، لفظتهم مقاعد الدراسة، في بلد ظلت تصرف على الصحة والتعليم مجتمعين أقلّ من ١%.
الثمار المرة التي قطفتها البلاد، جراء تلك السياسات التي سعت حثيثاً لربط أسباب الأرض بقيم السماء خلال ثلاثة عقود، هي تحويل المدارس إلى مأوى للنازحين. وقد أصبح في حكم الثابت، أنّ أيّ دولة، تصرف على الامن والدفاع أكثر من الصحة والتعليم، لا بُدّ أن تقوم فيها، حرب أهلية، وللأسف، ونحن في حضرة (اليوم العالمي للطفل)، نقف، عاجزون عن تقديم أيّ هدايا لأطفالنا، ولا أيّ شيء، غير المطالبة بوقف هذه الحرب.